النعمة والذنب
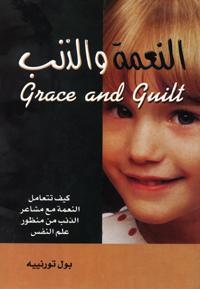
في الجزء الأول من هذا الكتاب، أو بالأحرى التحفة الفريدة لكاتبه بول تورنييه الطبيب السويسري، والذي ربما هو أفضل من كتب في المشورة المسيحية في القرن العشرين على الإطلاق، يقوم تورنييه بتحديد نطاق الذنب الإنساني حيث نرى بسهولة الدور الذي تلعبه مشاعر النقص في الشعور بالذنب، ففي حياتنا اليومية نحن نعيش غارقين في هذا الجو السقيم المشحون بالنقد المتبادل، إلى درجة أننا لا نكون منتبهين له فنجد أنفسنا منجذبين دون أن ندري إلى دائرة مغلقة لا يمكن التخلص منها: فكل توبيخ يثير شعوراً بالذنب في الشخص الذي ينتقد كما في الشخص الذي يقع عليه النقد، وكل إنسان يسعى إلى التخفيف من الذنب بأي طريقة ممكنة، سواء بانتقاد الآخرين أو بتبرير النفس.
وهنا يقول الكاتب عن الإيحاء الاجتماعي؛ إنه مصدر الكثير من مشاعر الذنب. فالصمت المستنكر، والنظرة الساخرة أو المستهزئة، والملحوظة التي تقال غالباً بدون تفكير، هذه الأشياء كلها قد تبلغ في تأثيرها إلى حد الإيحاء القوي. أما الذنب الحقيقي فهو بالتحديد ألا تجرؤ أن تكون نفسك. إن الخوف من أحكام الآخرين هو الذي يمنعنا من أن نكون أنفسنا، وأن نظهر أنفسنا كما هي على حقيقتها، وأن نكشف عن ميولنا ورغباتنا وقناعتنا، وأن نطور أنفسنا، وأن ننفتح بحرية وفقاً لطبيعتنا الخاصة. إن الخوف من أحكام الآخرين هو الذي يصيبنا بالعقم، ويمنعنا من أن نثمر كل الثمر الذي دعينا لإثماره.
وقد نكون مؤمنين، يقول تورنييه، ولاهوتيين، وعلمانيين من جميع الكنائس ومن جميع الطوائف، ولا سيما الأكثر حماساً في زيارة المرضى، ولكنا نسحق المريض باختباراتنا الدينية. فإن المبالغة في التأكيد على قدرة الله في شفاء من يضع ثقته فيه، يعطي الانطباع بأن الشخص المريض يفتقر للإيمان. والآن يضاف إليه ذنب آخر أشد خطورة ـ هو ذنب ديني في هذه المرة: أنه إذا لم يشفى فهذا لأنه غير مستحق لنعمة الله أو بسبب وجود معصية أو خطية غامضة وغير معروفة، تعوق الاستجابة.
ثم يتعرض بول تورنييه إلى عدة مسائل من جهة الإحساس بالذنب. فعن مسائل الوقت، يقول: إذا كان ضميرنا يؤنبنا على ضياع الوقت، فهو يؤنبنا أيضاً لأننا لا نعرف كيف نضيع الوقت، كيف نهون على أنفسنا، وكيف نستريح مثلما أوصانا الله؛ أو كيف نهدأ ونصلي ونقضي وقتاً في التأمل الهادئ. حيث إن أوقات التأمل هذه هي التي نسترد فيها سلامنا الداخلي الذي عالمنا اليوم في مسيس الحاجة إليه. إن الناس، يقول تورنييه، في حالة هروب طول اليوم. جميعنا في حالة هروب مستمر: في الصمت أو في النميمة؛ في الخمول أو في الملل؛ في ملذات المائدة أو في ملذات المكتبة؛ في ممارسة الرياضة أو في الجلوس بجوار المدفأة؛ في قراءة الصحف أو في حياكة الملابس... نحن نختبئ وراء الأنظمة الرسمية "حتى لا نرى مسئوليتنا" أي لنحمي أنفسنا من الشعور بالذنب، وهروبنا هذا في حد ذاته يسبب شعوراً أكبر بالذنب.
أن يكون الإنسان أميناً تجاه نفسه معناه أن يكون نفسه في كل الأوقات وفي كل الظروف، وفي وجود أي متحدث.
وعن مسائل المال: الشعور بالذنب بسبب الفقر ونظرات الازدراء أو التعالي أو الشفقة من الآخرين، هؤلاء الآخرين هم المذنبون بالطبع، ولكن الفقراء هم الذين يشعرون بالذنب. المشكلة ليست في الفقر والغنى بقدر ما هي في المقارنات المتبادلة بين الناس والتي لا سبيل إلى تجنبها. فنحن نشعر بالخزي بسبب عوزنا إلى المال، كما نشعر أيضاً بالخزي من امتلاكه واقتنائه. إننا جميعاً نشعر أن خضوعنا لله يظهر يومياً وبطريقة ملموسة في قراراتنا بخصوص المال. هنا أيضاً نسارع بالقول أن ما نملكه هو ملك لله، وأننا لسنا مالكين وإنما وكلاء.
أما الجزء الثاني من هذا الكتاب فهو يتأمل خطورة أن نناقش الذنب بطريقة موضوعية، وأن نتخيل أننا نستطيع أن نحكم من هو المذنب ومن هو غير المذنب.
الذنب الحقيقي والذنب الوهمي: ما هو معنى هذه المصطلحات بالضبط؟ ما هي المعايير التي بناء عليها سنقول إذا كان الشخص الذي يدين نفسه مذنباً حقاً أم لا؟
في رأي فرويد: أن مشاعر الذنب تنتج من القيود الاجتماعية فهذه المشاعر تتولد في ذهن الطفل عندما يؤنبه والداه. فهي ليست أكثر من مجرد الخوف من فقدان حب الوالدين. إنه الذنب الذي يتولد بالتنشئة، علاوة على الذنب الناتج عن الخوف من المحرمات (التابو). ونستطيع أن نقول أن هذا أيضاً يُسمى "الذنب الوظيفي" إي الشعور الذي ينتج عن الإيحاء الاجتماعي؛ الخوف من المحرمات أو من فقدان حب الآخرين.
أما "الذنب المتعلق بالقيمة" فهو الإدراك الصادق لدى الشخص بأنه قد تنكر لقيمة أصيلة؛ فهو حكم حر على الذات من الذات.
ومن وجهة نظر د.أودييه (الذي يقتبسه كثيراً تورنييه) يعتبر الذنب الوظيفي مرادفاً للذنب العصابي (المرضي) أو الوهمي، أما الذنب المتعلق بالقيمة فهو مرادفاً للذنب الحقيقي.
إذاً فالذنب الحقيقي عند الناس يأتي من الأشياء التي يوبخهم الله عليها في قلوبهم الداخلية. وهم وحدهم قادرون على اكتشاف ما هي هذه الأشياء، وهي عادة مختلفة تماماً عن الأشياء التي يوبخهم عليها الناس. إذاً "الذنب الزائف" هو الذنب الذي يتولد كنتيجة لأحكام وإيحاءات الناس، أم ا"الذنب الحقيقي" فهو الذنب الذي ينتج عن أحكام إلهية. إن أي ذنب ناتج عن إيحاء من أحكام الناس هو ذنب مزيف إذا لم يقابله دعم داخلي من أحكام الله. أفكار الله وأفكار الناس؛ أحكام الله وأحكام الناس؛ هذه هي الصيغة الواضحة للتمييز بين الذنب الحقيقي والذنب الوهمي.
الشيء المؤسف، يقول تورنييه، هو أن كل إنسان يفترض نفسه أنه يعبر من خلال أحكامه الشخصية، عن أحكام الله نفسه. إنهم يجعلون أنفسهم مترجمين لأفكار الله، إنهم مقتنعون تماماً برأيهم في الصواب والخطأ، إلى درجة أنهم يعتقدون أن الله سيكون منكراً لنفسه إذا لم يشاركهم في هذا الرأي. لهذا السبب فإن الذنب الوهمي النابع من أحكام البشر، والذنب الحقيقي المؤسس على أحكام الله، كثيراً ما يختلطان ويتشابكان على نحو خطير.
إذا كان الذنب الحقيقي هو التوبيخ الذي من الله، فكل ما أستطيع أن أفعله للمريض هو أن أساعده لكي يقترب من الله ويصغي إليه بنفسه، وليس أن ينتظر مني كلمات الحكم الإلهي.
كل إنسان يدافع عن نفسه. تحت هذا العنوان، يقول بول تورنييه أن أي إنسان يتعرض للاتهام يحدث لديه رد فعل دفاعي لتبرير الذات. هذا هو على الأقل رد فعل الشخص العادي. أما الشخص الذي يستسلم بسرعة، ويُنزل رايته بلا نقاش، ويقبل على الفور بالحكم الموقع عليه، فهذا يبدو شخصاً مريضاً. هذا الإنسان لديه إعاقة في غريزة الدفاع عن النفس. وسلوكه هذا يُنذر بالسوء في المستقبل. فالاعتراف السهل ليس اعترافاً وإنما هو استسلام. إن اعترافه الدائم بالخطأ "إني مخطئ" لن يعطي ثمراً حياً، لأنه نتاج آلية عُصابية، وليس نتاج تحرك حقيقي للروح. إنه دليل على الهزيمة وليس على الانتصار. إن التوبة الحقيقية لا تنشأ بهذه السرعة، فهي لا تتصف بالخاصية الأتوماتيكية، وكأنها شيء محدد سيكولوجياً، وإنما يتم التوصل إليها بعد صراع طويل، وبعد دفاع عاصف. وفوق كل شيء فإنه يتم التوصل إليها عندما ينشأ التبكيت على الخطية من الداخل وليس من الخارج، عندما يأتي من أعماق كياننا الشخصي، من الصلة الوثيقة مع الله، من تحريض الروح القدس، وليس من أحكام البشر.
إن الكتاب المقدس يضع علينا واجب الدفاع عن أنفسنا، وعدم السماح لأنفسنا بأن تتحطم تحت إدانة الآخرين، و تحت مطالبتهم المستمرة بأن يتخذوا دور القضاة على سلوكنا، وأن يمارسوا الرقابة الأخلاقية على حياتنا. ومن جانبنا، نحن مطالبون بملاحظة نفس التحفظ تجاه الآخرين وهو أن نتجنب إقامة أنفسنا قضاة على سلوك الآخرين.
إن يسوع نفسه رفض أن يقوم بهذا الدور القضائي عندما طُلب منه أن يفعل ذلك مع أنه هو الذي سيرجع ليدين الأحياء والأموات "لوقا12: 13-15". لقد رفض يسوع أن ينطق بأي حكم إدانة، ولكنه في الحال أيقظ إدراك سامعيه إلى طمعهم الشخصي.
أما الجزء الثالث من هذا الكتاب فنرى فيه كيف أن المسيح بكلمة الغفران يرحب بأولئك الذين يحتقرهم العالم، والذين يشعرون بذنبهم، وأنه على العكس إنما يتكلم بلهجة شديدة مع الأشخاص المغرورين الراضين عن أنفسهم الذين يكبتون أي شعور بالذنب. فالنعمة هي للمتواضعين و ليست للمغرورين الراضين عن أنفسهم. لذلك فإن الهزيمة، والانكسار وانهيار عالم مهيب بأكمله، قد يكون هو الطريق الوحيد إلى النهضة. مع كل واحد منا، قد تصبح الهزيمة بمثابة فرصة للرجوع إلى النفس والالتقاء الشخصي مع الله.
لذا يتعرض تورنييه لقضية التحرر من ذنب المحرمات (التابو)، ويقول: أننا في كل الكتاب المقدس، نستطيع إن نرى هذا التناقض بين العقليتين: العقلية الطفولية التقليدية، المتزمتة، المرتبطة بالمحرمات، والعقلية النبوية، على حد تعبير برجسون.
الأولى تقدم نظاماً أخلاقياً محدوداً ومحدداً، يركز الخطية في فعل محدد، أو شيء نجس محدد. وهو يدّعي إعطاء الإنسان خلاصاً يستطيع أن يحققه لنفسه من خلال الالتزام الدقيق، بينما هو في الواقع يجعله يغوص في كرب بلا شفاء.
والنوع الثاني يضع ذنباً في قلب الإنسان وليس في الأشياء، في النوايا وفي الكينونة وليس في الأفعال. إنه ينادي بعدم محدودية متطلبات الله، وبالتالي عدم مقدرة الإنسان على محو ذنبه من خلال كمال سلوكه الأخلاقي.
فالإجابة إذاً تأتي من الله، وليس من الإنسان، متمثلة في الغفران الذي يمنحه الله لأولئك الذين يعترفون بذنبهم الأكيد بدلاً من تبرير أنفسهم.
من الواضح جداً، يقول تورنييه، أنه لا يوجد إنسان يعيش خالياً من الذنب. فالذنب يشمل الجميع بلا استثناء ولكن بحسب ما يتم إخماده (إسقاط الذنب على الآخرين أو على الله) أو الاعتراف به، فهو يدير إحدى عمليتين متناقضتين: إذا تم إخماده، فإنه يؤدي إلى الغضب، التمرد، والخوف، والقلق، وإماتة الضمير، والعجز المتزايد عن الاعتراف بالأخطاء، والسيطرة المتزايدة للميول العدوانية. أما إذا تم الاعتراف به بطريقة واعية، فهو يؤدي إلى التوبة، والسلام، والأمان الناتجين عن الغفران الإلهي، وبالتالي إلى نقاء متزايد للضمير، وتناقص مستمر للدوافع العدوانية.
وأخيراً في الجزء الرابع من هذا الكتاب الرائع يقدم الكاتب الإجابة على مشكلة الذنب متمثلة في ما يسميه بالإلهام الإلهي، أي الخيط الإرشادي الذي يقود إلى الحل الحقيقي للذنب، وهو العلاقة الشخصية مع الله. حيث في العلاقة الوثيقة مع الله، يحدث تحول جذري في الطريقة التي بها نحكم على أنفسنا. فبدلاً من الاهتمام الحرفي بما هو مسموح به وما هو محرم من حيث المبدأ، يتحول التركيز إلى الدوافع الأساسية التي تؤثر على أفعالنا. هذا يذكرنا، يقول تورنييه، بتأثير التحليل النفسي على المرضى والذي يقودهم إلى إدراك دوافعهم الخفية.
لا يوجد شئ بلا ثمن، كذلك ذنبنا، إنما الله هو الذي دفع الثمن: كيف؟ هنا يضع تورنييه بضعة أسئلة صعبة ويواجهها بعمق وبراعة دونما التفاف، مثل: هل غفراني للآخرين مطلب شرطي من خلاله استحق أنا الغفران؟ هل الاعتراف شرط لغفران الله؟
فيقول أنه في إمكاننا أن نرى التوبة والغفران كشرط موضوع من الله، أو على العكس كخريطة للطريق أو علامة على الطريق وضعها يسوع في حكمته وبصيرته السيكولوجية ومحبته ليرينا أين يوجد الطريق الذي يخلصنا من يأسنا. كذلك الاعتراف، قد نراه على أنه شرطاً للغفران أو أنه بالحري الطريق إلى الغفران.
في النهاية يختم تورنييه كطبيب بنصيحته الجميلة التالية:
لا تحاول أبداً (كطبيب/ أو كمشير) أن توقف المريض أثناء اعترافاته، حتى إذا كانت تبدو غير مؤذية. فهي أشبه بالمسافة التي يجريها الرياضي حتى يتمكن في النهاية من تحقيق قفزة صعبة. كذلك لا ينبغي أن تقطع الصمت الشديد الذي قد يفرض نفسه فجأة على الحديث. ففي هذه اللحظة يدور صراع عنيف في نفسه، وربما تفسد العملية بإعطائه فرصة للانحراف عن الموضوع الرئيسي.
إن المرضى يتحدثون معنا (الأطباء) عن أمراضهم، وأعراضهم، وصراعاتهم، في الحقيقة هم يصفون كل شيء بوضوح. ولكنهم جميعاً يتوقعون منا شيئاً أكثر من مجرد اهتمامنا الفني: ليس فقط تعاطفنا، أو اعتنائنا الشخصي، أو تشجيعنا، ولكنهم يتوقعون أيضاً بطريقة ما وبدون أي إقحام، شعاعاً من النعمة الإلهية التي تستطيع وحدها أن تمحو الذنب. وهذه خدمة روحية كهنوتية يدعونا الله إليها؛ وعندما نمارسها فنحن لا ننافس الكنيسة وإنما نتعاون معها.
إننا مدعون لمساعدة مرضانا ليس فقط في متاعبهم الجسدية أو النفسية وإنما في متاعبهم الروحية، ولكن بدون أي محاولة لتغيير معتقداتهم الدينية.
إن الطب بامتناعه عن الدخول في أي مسائل روحية، قد حكم على نفسه بالانحصار في جانب واحد من جوانب الإنسان. ويمكن القول إنه اليوم لم يعد له أي مفهوم عن الإنسان بالمرة.